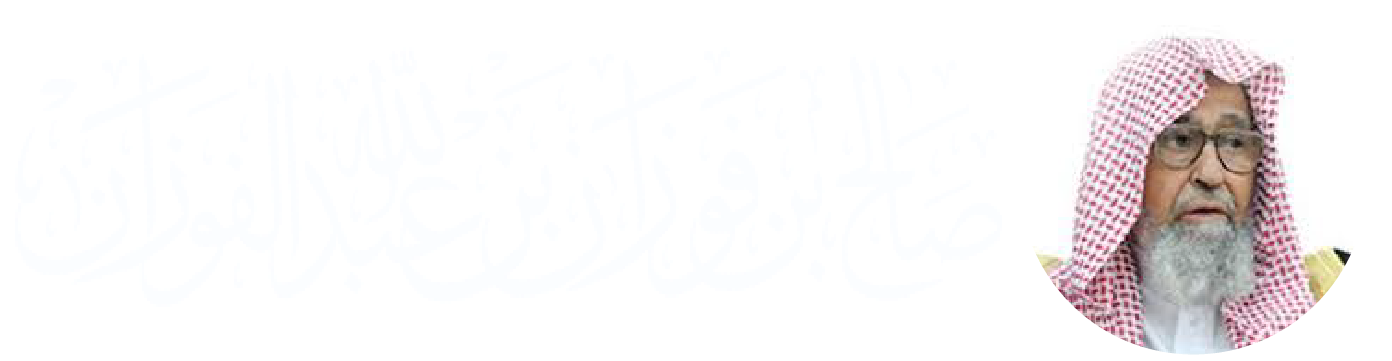الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد..
فهذا الكتاب اسمه كتاب (الأربعين)، اقتصر مؤلفه على أربعين حديثا، لأنه ورد في فضل من جمع للأُمّةِ أربعينَ حديثاً، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: « مَنْ حَفِظَ على أُمَّتِي أربعينَ حديثا من أَمرِ دِينِها بعثهُ اللهُ يومَ القيامةِ من زمرةِ الفقَهاءِ والعلماءِ»، وفي رواية: «وكنتُ لهُ يومَ القيامةِ شافعًا وشهيداً».
فالإمامُ يَحيَى بنُ شَرفِ النَّوَويُّ أرادَ أَنْ يَظفرَ بالأجرِ العَظيم ؛ فاختارَ هذهِ الأحاديثَ الجوامعَ في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، جمعها في هذا المُؤَلَّف الصغير في حجمهِ، لكنه عَظيمٌ في فَائدتهِ وفَضلهِ، انتقاها من الأحاديث الصحيحةِ والحَسنةِ، ثُم جاء الإمام ابنُ رَجَب - رَحِمَهُ الله - فزادَ عليها عَشرَةَ أحاديثٍ فصارت خمسينَ حديثاً، وشرحَ عليها في كتابه «جامعُ العلومِ والحِكَم»، وهو شرح حافل بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الكتاب، فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم مفيد عظيم، وهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثاً.
والإمام النَّوَويُّ - رحمه الله - كان إماماً عظيماً متخصصاً في مخُتَلفِ العلوم، فكان متخصصاً في الحديثي، والفقه، واللغة العربية، وكان لمؤلفاته قَبول عند المسلمين؛ وذلك - والله أعلم - لنيتهِ الصالحة وإخلاصه لله عزَّ وجلَّ، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب (الأربعون)، ومنها (ریاضُ الصالحين)، ومنها (شرح صحيح الإمام مسلم)، ومنها مؤلفات في الفقه معتمده في مذهب الإمام الشافعي، فهو إمام جليل، وقد ألقى الله القبول لمؤلفاتهِ وانتفعَ بها المسلمون، ولا يزالون يَرجِعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان، فرحمة الله عليه من إمامٍ جليل.
الحديث الأول
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب t قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوَى، فمَن كانَتْ هِجرَتُه إلى اللهِ ورسولِه، فهِجرَتُه إلى اللهِ ورسولِه، ومَن كانَتْ هِجرَتُه لدُنْيا يُصيبُها، أو امرأةٍ يتزَوَّجُها فهِجرَتُه إلى ما هاجَرَ إليه » . رواه إماما المحدثين أبو عَبدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهْ البخاري، أَبُو الحُسَيْنِ بنُ الحَجَّاجِ بنِ مُسْلِمٍ القُشَيْرِيُّ النّيسَابوريُّ في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصُنَّفة.
وهذا الحديث من الأحادي الجوامع، والنَّبِيُّ ﷺ قد أوتي جوامع الكلم وفضل الخطاب، وكان يتكلم بكلماتٍ يسيرةٍ تجمع علوماً غزيرةً وخیراتٍ كثيرة، وهذا الحديث قال عنه أهل العلم: إنه أحدث الأحاديثِ الأربعةِ التي يدور عليها الإسلام، وهي:
أولاً : هذا الحديث « إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ».
ثانياً : حديث: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ ».
ثالثاً : حديث: «وازهَدْ فيما في أيدي النَّاسِ؛ يُحبَّكَ النَّاسُ ».
. رابعا : حديث: «مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » .
ولهذا يقول الناظم:
عُمْدَةُ الدِّينِ عندَنا كلماتٌ أربعٌ مِنْ كلامِ خيرِ البريَّة
اتَّق الشُّبهَاتِ وازهَدْ ودَعْ ما لَيسَ يَعْنِيكَ واعمَلَنَّ بِنيَّة
هذه أربعة أحاديث: قوله: (اتَّق الشُّبهَاتِ) هذا آخرُ حديث: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ ».
(وازهَدْ) هذا من حديث: «وازهَدْ فيما في أيدي النَّاسِ؛ يُحبَّكَ النَّاسُ ».
(ودَعْ ما لَيسَ يَعْنِيكَ) من حديث: « مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » .
(واعمَلَنَّ بِنيَّة) أخذاً من هذا الحديث: « إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ »..
قولهُ ﷺ : « إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ». (إنَّما) أداةُ حصر تُثْبتُ الحُكم لما بعدها وتنَفيهِ عمَّا قبلها، كما في قَولهِ تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ([التوبة: 60]، فهي من أدوات الحصر، والحصر معناه: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما قبلها، وقوله: « إنَّما الأعمالُ » أي: اعْتبارُ الأعمالِ عندَ الله - جَلَّ وعَلا - «بالنِّيَّاتِ » أي بمقاصدِ أصحابِها، والنِّيَّاتُ: جمع نية وهي القضُ في القلب، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل، فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله، وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله.
هذا ما يدل عليه الحديث، وهو من جوامع الكلم، فقوله ﷺ:«إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» أي: بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم، فينبغي للمُسلم أن يُخلِص نيّته للهِ في كُلِّ عَملٍ يعملهُ من الأعمال الصالحة، فالمراد بالأعمال هنا العبادات، أما الأعمال الُّدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نيّة، مثل أن يأكل أو شرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته، هذه لا تحتاج إلى نية، وإنما المقصود بالأعمال أعمال الطاعات، فهي التي لابُدَّ أن تُؤسَّسَ على نيّة.
ثم قال : « وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوَى »، هل هذه الجملة مُؤكِّدَةٌ للجملة التي قبلها، أو هي مُستقلِّة؟ فيها قولان:
القول الأول: من العلماء من يقول: إنها مُؤكِّدَةٌ للجملة التي قبلها، ومُقرِّرةٌ لما تدلُّ عليه.
القول الثاني: إنها مُؤسِّسةٌ وليست مُؤكَّدة، وهذا أرجح؛ لأنّ حَملَ الكلام على التأسيس أولى من حَملهُ على التأكيد، فيكون قولهﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» يُرادُ به أنَّ اعتبار العمل بنية العامل صحةً وفساداً، فإن كانت نيته لله - عزَّ وجلَّ - فعملهُ صحيح، وإن كانت نيَّتهُ لغير الله فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد.
وأما قوله : « وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوَى »، هذا من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيَّتهُ لله، فإن كانت نيَّتهُ لغيرِ الله فإنه ليسَ لهُ ثوابٌ عند الله جلَّ وعَلا، كما قال تعالى: )مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ١٦ ( [هود:15،16]
وقد جاء في الحديث أن النَّبِيَّ ﷺ قال: « إنَّ أوَّلَ الناسِ يُقْضَى يومَ القيامةِ عليه رجلٌ اسْتُشْهِدَ ، فأُتِيَ بهِ ، فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فعَرَفَها ، قال : فما عمِلْتَ فيها ؟ قال : قاتَلْتُ فِيكَ حتى اسْتُشْهِدْتَ ، قال : كذبْتَ ، ولكنَّكَ قاتَلْتَ لِيُقالَ جِريءٌ ، فقدْ قِيلَ ، ثمَّ أُمِرَ بهِ فسُحِبَ على وجْهِهِ حتى أُلْقِيَ في النارِ»، لماذا ألقي في النار مع انه قُتل في المعركة وصورتهُ أنَّه يُجاهد في سبيل الله؟
الجواب: لأن نيَّتهُ ليست لله، وإنما نيَّتهُ أن يُمدح بالجراءة والشجاعة، وقد قيل هذا في الدنيا، وحصل على ما قَصد من مدح النَّاس له، فليس له في الآخرة عند الله ، والله لا يظلمُ النَّاس شيئاً.
والثاني: «ورجلٌ تعلَّمَ العِلْمَ وعلَّمَهُ ، وقَرَأَ القُرآنَ ، فأُتِيَ بهِ فعَرَّفَهُ نِعمَهُ ، فعَرَفَها ، قال : فما عمِلْتَ فيها ؟ قال : تعلَّمْتُ العِلْمَ وعلَّمْتَهُ ، وقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ ، قال : كذبْتَ ، ولكنَّكَ تعلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقالَ عالِمٌ ، وقرأْتَ القُرآنَ لِيُقالَ : هو قارِئٌ فقدْ قِيلَ ، ثمَّ أُمِرَ بهِ فسُحِبَ على وجْهِهِ حتى أُلْقِيَ في النارِ ». وهذا ما يُوجب لطالب العلم أن يُخلص نيَّته الله - عزَّ وجلَّ - في طلب العلم، فلا يكون قصده الترَّفع، أو الوظيفة الدنيوية وتحصيلُ الحُطام بعلمهِ وتعليمه، وإنّما يكون قصده لله عزَّ وجلَّ، لأنّ تَعلُّم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة فلا يصرفهُ ويريدُ به الدنيا، وإنما يريد به وجه الله، وما يعطي له من مالٍ إن أُعطي فهو تابع وليس مقصوداً.
والثالث: رجل آتاه الله مالاً سلّطه على هلكته في الخير، فصار ينفقه في الخير، فهو في الظاهر كثير الإنفاق، والإنفاق في سبيل الله لا شك أنه من أفضل الأعمال، قال : «.. ورجُلٌ وسَّعَ اللهُ عليْهِ ، وأعْطاهُ من أصنافِ المالِ كُلِّهِ ، فأُتِيَ بهِ فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فعَرَفَها ، قال : فمَا عمِلْتَ فيها ؟ قال : ما تركْتُ من سبيلٍ تُحِبُّ أنْ يُنفَقَ فيها إلَّا أنفقْتُ فيها لكَ ، قال : كذبْتَ ولكنَّكَ فعلْتَ لِيُقالَ : هوَ جَوَادٌ ، فقدْ قِيلَ : ثمَّ أُمِرَ بهِ فسُحِبَ على وجْهِهِ ، ثمَّ أُلْقِيَ في النارِ».
فإذا كانت هذه الأعمال الجليلة تذهب هدراً وتضيعُ على صاحبها يوم القيامة نظراً لنيَّات أصحابها وسوء قصدهم فيها من الأعمال من باب أولى، هذا ما يؤكد على المسلم أن يخلص نيَّته لله - عزَّ وجلَّ - عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة، من صلاة، وصيام، وحج وعمرة، وصدقة، وطلب للعلم والتعليم، وأمر بالمعروف ونهي عن المُنكر، ودعوة إلى الله عز وجل، وغير ذلك، فينبغي أن يراقب نيَّتهُ ويتذكر نيَّتهُ في كل عمل يعمله بأن يخلصه لله، ويطرد عن نفسهِ الرياء؛ لأن الإنسان بشر يَعرضُ له الرياء و المدح وحب الثناء، عليه أن يطرد هذا القصد إذا طَرأ عليه، ويخلص نيَّتهُ لله عزَّ وجلَّ.
وقد قال الشاعر في حُبِّ الثناء:
يَهْوَى الثَّنَاءَ مُبَرِّزٌ وَمُقَصِّرٌ ... حُبُّ الثَّنَاءِ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ
فالإنسان بشرٌ يَعرض له هذا القصد ، من حبِّ المدح وحب الثناء ، فعليه أن يطردهُ ويتخلّص منهُ، ويُخلص نيَّتهُ لله عز وجل
ثم إنّه ﷺ ذکرَ مثالاً عمليّاً لهذا الحديث، فقد مثّل بالهجرة، والهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراَ بالدِّين، فهي من أفضل الأعمال وهي قرينة الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: )إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ( [الأنفال:72] والله - جلَّ وعلا - قدَّمَ المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء؛ لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نُصرة لدين الله - عزَّ وجلَّ - فهم أفضل من غيرهم، فالهجرة شرفٌ عظيمٌ وعملٌ جليلٌ، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، إنما العبرة بمقصد صاحبها، فإن هاجر يريد نُصرة الله ورسولهِ، فهجرتهُ إلى الله ورسوله نظراً لنيِّتهِ، وتكون عند الله مقبولة، ويكون لهُ ثواب المُهاجر، فإن خرج للهجرة ومات في الطريق كُتب له أنه مهاجر، كما قال تعالى: )وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ([النساء: ۱۱۰]، نظراً لنيَّتهِ الصالحة يكتب الله - جلَّ وعلا - لهُ أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق، هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسولهِ، أي : لنُصرةِ دين الله وحُبّاً لله وحُبّاً للرسول ﷺ.
والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة؛ لقوله ﷺ : «لا تَنقطِعُ الهِجرةُ حتى تنَقطِعَ التَّوبةُ، ولا تَنقطِعُ التَّوبةُ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها»(۱)،
فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائماً وأبداً، فإذا شقَّ عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار الدين هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه،
)وَمَن يُهَاجِرۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُرَٰغَمٗا كَثِيرٗا وَسَعَةٗۚ ([النساء: ۱۰۰]، فليُهاجر فراراً بدينه إلى بلدٍ يستطيع فيها أن يُظهر دينه، ويتمكّن من عبادة ربِّه عزَّ وجل، وأما قوله ﷺ: « لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ »، فالمُراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة؛ لأنها لمّا فُتحت على يد رسول الله ﷺ صارت بلد إسلام، فلا يُهاجر منها، إنما كان يُهاجر منها عندما كانت في قبضة الكفار، وكانوا يضايقون المسلمين ويصدّونهم عن دينهم، فلما فتحها رسول الله ﷺ صارت بلاد إسلام، فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح لا يُسمَّى مُهاجراً؛ لأن الهجرة حينئذ ليس لها موجب، ومكة أفضل من المدينة ومن غيرها من البلدان، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية، ولا تعارض بين الأحاديث.
قوله ﷺ : «فمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ..» هذا هو القسم الأول: وهو الذي أخلص نيَّته لله في الهجرة وتقبل الله هجرته وكَتبهُ في المهاجرين في أي وقت كان؛ لأن الهجرة باقية، ولا يقال: إن هذا خاصٌّ بما كان قبل الفتح، بل هي باقية كُلما أُحتيج إليها، فهي متنوعة، ومن هاجر في أي وقت فله تواب المهاجرين.
القسم الثاني: من كانت هجرته لغير الله، فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد، وليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال ﷺ : « ومَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ..» ، أي: هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وليس قصده الدين، وإنما قصده أن بلاد المسلمين فيها طمع، وفيها دنيا، وفيها تجارة، وفيها ملذات، فهجرته للدنيا وليست لله عزّ وجلّ، ولا يُكتب لهُ ثواب المهاجر، وإن كانت صورة عمله أنّه مهاجر، ولكن النظر للقصد والنيَّة وليس للصورة، فإذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الرفاهية، أو من أجل الطمع الدنيوي، أو التجارة، أو العيش الرغد، فهذا لا يُكتب مع المهاجرين، وليس له ثواب، بهجرته.
قال ﷺ : «أوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُها»؛ كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلَّق قلبه بها، وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلادها، فهي في بلاد الإسلام وهو متعلق بها وقالت له: أنا لا أتزوجك في بلاد الكفر. فهاجر إلى بلاد الإسلام؛ لأجل أن يتزوجها، فهذا ليس له ثواب الهجرة عند الله، وإن كانت صورة عمله هي صورة الهجرة، ولكن لما كان قصده ليس الدِّین، وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جلَّ وعلا، وأفلسَ من ثواب المُهاجر، والله - جلَّ وعلا - يعلم ما في القلوب، قال تعالى: ) قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ١٦ ( [الحجرات: 16]، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله وجل، أما الناس لا يعلمون.
والنيَّة محلُّها القلب لا يعلمها إلا الله، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول المسلم: نويت أن أصلي، أو نويت أن أحج، أو نويت أن أتصدق؛ لأن هذا بدعة، لأن النيَّة محلها القلب، وهي عمل قلبي وليت عمل لسان، وفي المجاهرة بها رياء، ولم يثبت أن الرسول ﷺ تلفظ بالنيّة عندما كان يريد الصلاة، أو يريد أي عمل من الأعمال، تم جاء عنه ﷺ أنه في حجَّة الوداع أحرم بقوله: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، هذا ليس تلفظاً بالنيَّة وإنما هو تلفظ بالمنوي، وهو النُسك الذي يريد: هل يريد حجّاً؟ هل يريد عمرةً؟ هل يريد أن يُقرِن بين الحجّ والعمرة؟ هل يريد أن يُفرد بالحجّ؟ هل يريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ فهو يعني النُسك الذي يريده، وليس المُراد أنه ينطق بالنيِّة، فهو لا يقول: نويت الحج، أو نويت العمرة، أو نويت التمتع، أو نويت القِران، ولا يقول: أريد الحج، أو أريد العمرة. كلمة (أريد) لا تجور، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، ولكن هذا غلط، وإنما الذي ورد عن الرسول ﷺ التلفظ بالنسُك من باب التعيين للنسُك الذي يريده لا من باب النطق بالنيِّة.
فلا يجوز التلفظ بالنيِّة لا عند الطلاق، ولا عند الزكاة، ولا عند أي عمل يعمله، بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنيِّة ؛ لأن الله يعلم ما في قلبه، حتى لو قال: إنه ينوي وجه الله. وهو ليس كذلك، فالله يعلم ما في قلبه، ولا يفيد هذا اللفظ، فالتلفظ بالنيِّة بدعة؛ لأن محِلَّها القلب، والجهر بها بدعة، وهو أيضا رياء، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنيِّة عند الطواف، وعند الصلاة، وعند أي عمل يعملونه، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال بالتلفظ بالنيِّة. فهذا مردود من وجهين:
أولا: هذا لم يصحّ عن الإمام الشافعي
ثانيا: لو صحّ عن الإمام الشافعي فلیس حُجَّة ؛ لأن الإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الرسول ﷺ ، لا في كلام الشافعي ولا أحد ولا أبي حنيفة ولا مالك، ولا يكون قول العالم حُجَّة إلا إذا وافق الدليل.
ثالثا: الذي رُوي عن الشافعي أنه قال: الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لا يُدخل فيها إلا بذكر الله. والمراد بالذكر: التكبير.
فعلى كل حال النيِّة عملٌ قلبيٌّ، ولا يجوز التلفظ بها، والله أنكر على الأعراب الذين قالوا: ) آمَنَّا (، فقال - جل وعلا - مخاطباً رسوله:) قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ( [الحجرات 16]، إلى قوله: )قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ( [الحجرات 16] فالله سبحانه لا يحتاج أن تُعلمه عن نيتك بقولك: أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا، الله يعلم هذا بدون أن تخبره سبحانه وتعالى، فعليك بإصلاح النية وإسرار النيِّة وعدم التلفّظ بها.
وأما التلفّظ عند ذبح الأُضحية فليس تلفُّظا بالنيِّة ؛ لأنّ قولهُ : « اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ» هذا دعاء وتلفّظ بالمنوي وليس لفظاً بالنيَّة، وهو مثل التلفظ بالنُسُك، فإذا ذبحتَ الأُضحية فإنك تُعيّن الذي قصدته، هل هو لك أو لوالدك أو لأحد؟ فمن أجل التمييز تُعيّن الذي قصدته .